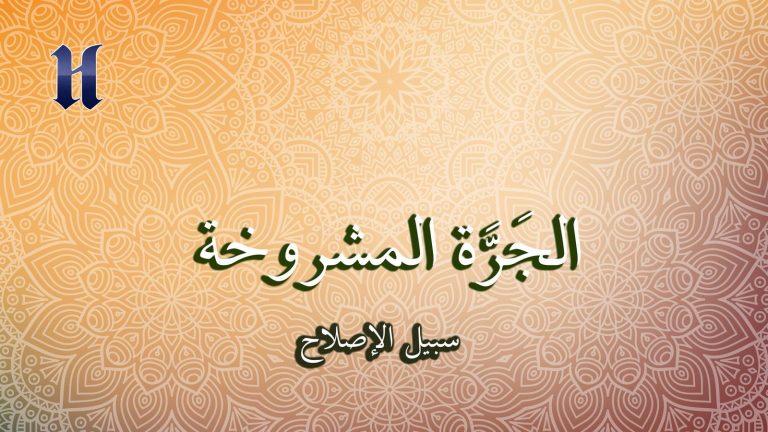سؤال: ما الذي يجب مراعاته حتى لا يكون تنوّع المشاعر واختلافُ الأفكار التي يحملها مَنْ يسيرون نحو هدفٍ واحدٍ سببًا للفرقة والخلاف؟
الجواب: بادئ ذي بدء أرى من المفيد التركيز على نقطةٍ أشِير إليها في السؤال أيضًا، فمن الأهمية بمكان أن يكون للإنسان غاية مثالية، وأن يحدّد لنفسه هدفًا ومقصدًا واضحًا، فالإنسان الذي يخرج لتبليغ دين الله في كل الأرجاء عليه أن يستوعب جيّدًا منذ البداية ماهية الطريق التي يسلكها، وخصوصياتها، وما الذي ستقوده إليه هذه الطريق، ولا يكتفي بربط الأمر بالتصديق العقلي، بل يحرص على أن يسير قلبه ومشاعره ولطائفه في نفس الاتجاه الذي يسير فيه عقله، وأن يحصر همّته ويبذل وسعه في سبيل تحقيق غايته المثالية، وأن يظلّ في هذا الاتجاه على الدوام.
القواسم المشتركة
فإذا كان هؤلاء الأشخاص المختلفون فكرًا وشعورًا قد تكاتفوا من أجل قضيّةٍ واحدةٍ، وحدّدوا الطريق التي يسيرون فيها والغاية التي يطمحون لتحقيقها، وتمكنوا من إقامة التعاون والتناغم القلبي فيما بينهم؛ فهذا يعني أن ثمة قواسم مشتركة تجمع بينهم.. ولا ننسَ أنه كلما زادت القواسم المشتركة بين الناس، وكلما زاد وعيهم بها؛ كان من السهل عليهم التفاهم والاتفاق؛ ولهذا السبب لفت بديع الزمان سعيد النورسي الانتباه إلى النقاط المشتركة التي تجمع بين المؤمنين في رسالته “الأخوة”، ورتّبها على حسب الأهمّيّة وسردها واحدةً تلوَ الأخرى.. وهذا أمرٌ لا بدّ من التأكيد عليه؛ فثمّة حاجة ماسّة إلى تحديد القواسم المشتركة واستيعابها جيدًا، ومن ثمّ تفصيلها، وتبليغها للناس بأسلوب لائق.
على سبيل المثال قد لا يكفي بالنسبة للجميع الحديثُ عن القاسم المشترك للإسلام من أجل إقامة الوفاق والاتفاق بين المسلمين، فهذه القضية تحتاج إلى مزيد من التفصيل والشرح ومشاركة المشاعر والأفكار، ولقد أشار الأستاذ النورسي رحمه الله إلى هذا الأفق بقوله: “إن خالقكم واحد، مالككم واحد، معبودكم واحد، رازقكم واحد… وهكذا واحد واحد إلى أن تبلغ الألف، ثم إن نبيكم واحد، دينكم واحد، قبلتكم واحدة… وهكذا واحد واحد إلى أن تبلغ المائة، ثم إنكم تعيشون معًا في قرية واحدة، تحت ظل دولة واحدة، في وطن واحد… وهكذا واحد واحد إلى أن تبلغ العشرة”[1].
والمقصود مما ذُكر هنا من أعداد مثل العشرة والمائة والألف ليس الكم بل الكيف، فبديع الزمان يلفت الانتباه بهذه الأعداد إلى أهمية القواسم المشتركة، فيعبر عن أهمية الكيف بالكم، وكما أن حقيقة الوحدانية تسبق حقيقة النبوة، فلا شك أن وحدة الدين والقبلة أسمى وأعلى من أن تُقارن بوحدة القبيلة أو العشيرة التي ينتسبُ إليها، فلو حُدّدت القواسم المشتركة بشكل جيد، وأُكِّدَ عليها في كل مناسبة؛ وتقبّلها الإنسان في عالمه القلبي والعقلي؛ فمن الممكن حينذاك منع الصراعات والنزاعات بنسبة كبيرة.
كلُّنا بشرٌ، نحمل أنواعًا مختلفة من الحساسيات ونقاط الضعف، ولا ريب أننا ننزعج أحيانًا من كلام البعض أو أفعالهم أو تصرّفاتهم، إلا أن للقواسم المشتركة التي تحدثنا عنها آنفًا تأثيرًا قويًّا في توحيد الصف وجمع الكلمة؛ حيث إن من يأخذ هذه القواسم بعين الاعتبار ويستخدم إرادته في هذا الاتجاه يمكنه أن يتجاهل عوامل الانقسام والإقصاء، ويغض الطرف عنها.. فإن عِظمَ القواسمِ المشتركة التي تُلزمنا بالوحدة والاتحاد تُصغِّر في عينيه عوامل الصراع وتقضي عليها، فيبادر هذا الشخص إلى أن يقمع بإرادته العديدَ من السلبيات التي لا يستطيع تقبّلها وفقًا لطبيعته الشخصيّة، ويقول: طالما ربنا واحد، ونبيّنا واحد، وقبلتنا واحدة، ونتقاسم همًّا واحدًا، ونعيش معًا في بلدة واحدة، ونسعد بأشياء واحدة، ونتعرض لهموم واحدة، فلِم أفسد الأخوة التي بيني وبين إخوتي؟!”.
الوفاء بحق الإرادة
ورغم ما ذكرناه فلا بدّ أن ندرك أنه لا يمكن تجنّب الخلافات تمامًا مهما فعلْنا، وهذا يرجع إلى سببين رئيسين:
الأول: أن الإرشاد والتبليغ والنزعةَ إلى الخير والتربيةَ قد لا يحدثون التأثير نفسه عند الجميع، فمهما حاولتم إقناع الناس بأيِّ غايةٍ مثاليّة، أو اجتهدتم في إعادة تأهيلهم أو في إنعاش المشاعر الإنسانية بينهم؛ فسيكون هناك بالتأكيد أناسٌ يتبعون النفس والشيطان، وقد لا يُحدث الوعظ والنصيحة والتبليغ والإرشاد التأثيرَ نفسه في الجميع.
الثاني: أن الله تعالى خلق الناس مختلفين، وخصّ كلَّ فردٍ بسمات متباينة، فإن لم تُراع هذه الاختلافات؛ فقد تتحوّل إلى أداة للنزاع والصراع.
لذا فعلينا أن نفي بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأن نبذل قصارى جهدنا لإبعاد الناس عن الأفعال والسلوكيات غير الإنسانية، وأن نبيّن لهم أنه لا يجدر بالإنسان الاعتداء على الآخرين واغتصاب حقوقهم والشجار معهم ومناطحتهم، ينبغي أن نسعى كلَّ ما في وسعنا في سبيل انسلاخ الناس عن الحيوانية، وانفصالهم عن الجسمانية، وارتقائهم في مدارج حياة القلب والروح.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمّةً واحدة ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم.. لو شاء الله لجعل الناسَ على مشربٍ واحدٍ ومزاجٍ واحدٍ، وبالتالي فلا تتباين أفكارهم ومشاعرهم، ولا يتنازع أحدٌ مع أحدٍ، ومن ثم لا تعد هناك حاجة إلى الإرادة، بيد أن دخول الجنة تفضُّلٌ من الله على الإرادة على مستوى الشرط العادي، فالإيمانُ وفهم الإسلام والوصولُ إلى مشاعر الإحسان؛ كلُّها جماليّات أسبغها الله على الإرادة، والله تعالى ميّز الإنسانَ عن باقي المخلوقات بالإرادة، بل إن الإنسان يتميز عن الملائكة بقدرته على استخدام إرادته؛ لأن الملائكة لا يملكون إرادةً بالمعنى الذي نعرفه أو لديهم إرادة لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون.
وهكذا فإن ما يقع على عاتق الإنسان الذي تميّز عن سائر المخلوقات بالإرادة والاختيار هو الوفاء وإعطاء الإرادة حقها؛ حتى يستطيع العمل مع إخوانه في وفاقٍ واتّفاق، المهمّ هو أن يكون الإنسان قادرًا على القيام بذلك دون إثارة ضجّةٍ أثناء السير في الطريق متّجهًا نحو الهدف، وأن يكون على توافقٍ حتى مع الذين لا يفكّرون مثله، ولا يتصرّفون مثله، ويخالفونه في أفكاره ومشاعره. أجل، قد يتلاعب البعض بأعصابنا، وقد يخالفوننا في أحوالهم وأفعالهم وأفكارهم ومشاعرهم، وربما ننزعج بسير بعضهم وضحكهم وإيحاءاتهم، لكن الله تعالى قد أعطانا سلاحًا مهمًّا للتغلّب على مثل هذه المشاعر السلبية، فلو استخدمناه في محلّه؛ فلن نخضع لتأثير مثل هذه المشاعر والأفكار السلبية، ولن نسمح بانعكاسها على أفعالنا وتصرفاتنا، بل إننا ربما سنرى هذه الأفعال المنفّرة القبيحة بالنسبة لنا الآن أشياء جميلة ورائعة في المستقبل.
وجهة نظر
ولو لاحظنا فإن معظم المواقف والسلوكيات التي تصيب الناس بالتوتّر والعصبية ليست من الأشياء التي يحظرها الدين، غالبًا ما يرجع هذا الأمر إلى تقييماتنا الذاتية وعاداتنا ووجهات نظرنا، فمن يفكر بسلبيّة وينظر إلى من حوله بسلبيّة يرى المشكلات في الجميع، فيجد في كلّ واحدٍ فيهم ما يعيبه عليه أو ينتقده فيه، فنراه ينزعج من كلام هذا، ومن وقع أقدام ذاك، ومن نمط عمل ذلك، ومن سلوكيات هؤلاء.
ولبديع الزمان سعيد النورسي كلامٌ نفيسٌ في هذا السياق، حيث يقول: “مَنْ أحسن رؤيته حَسُنتْ رويّته وجمل فكره، ومن جَمُلَ فكرُه تمتّع بالحياة”[2]، فإذا نظرنا إلى الأمر بشكل معكوس فسنلاحظ أن الشخص الذي يفكر بسلبية، ولا تقع عينه دومًا إلا على الجانب القبيح من الأشياء، ويضخّم الأشياء الصغيرة؛ فإنه دائمًا يسخط على حياته، وينزعج ويضيق صدرُه من كل ما يراه ويسمعه؛ لأنه يقيس كلَّ مسألةٍ بمعاييره الذاتية، والأدهى من ذلك أنه يحكم منذ البداية على أيّ موقفٍ أو سلوكٍ بأنّه مزعج، ولا ينفكّ عن التفكير في ذلك في حِلِّه وترحاله، فيجعل حياته غير قابلة للعيش فيها، ولو أنه عوّد نفسه على التفكير بشكلٍ جميلٍ؛ فسيتجاهل ويتعامى بعد فترة كلَّ هذه الأمور السلبية، فلا يزعجه تنوُّع المشارب والأمزجة والمذاهب. ولكن أنوه مرة أخرى على أن هذا منوطٌ باستيفاء الإرادة حقها، وبذل الجهد قليلًا.
الجنة محفوفة بالمكاره
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكارِهِ“[3] وهذا يعني أننا سنواجه صعوباتٍ شديدةً على النفس عند السير في طريق الجنة، فكما أن أداء العبادات على الوجه الأكمل، والابتعادَ عن المحرمات يثقلان على النفْس؛ فإن تحمُّلَ رفقاء الطريق، والصبرَ على أذاهم وجفائهم أيضًا؛ لَيُعدَّان من مشاقّ الطريق إلى الجنة.
ويتوقّف التغلّب على هذه الصعوبات على التعمّق في الإيمان، والتخلّق بأخلاق الإسلام، فإذا أصبح الناس يعانقون بعضَهم ويتراحمون فيما بينهم بعدما كانوا في الجاهلية ينهش بعضُهم لحم بعضٍ، ويتناحرون فيما بينهم؛ فهذا يرجع إلى التخلّق بأخلاق القرآن والإسلام، لا ريب أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ذوي أمزجة وطبائع مختلفة، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه كان يختلف طبعه تمامًا عن طبع عمر رضي الله عنه، وكذلك كان أبو ذر وعثمان رضي الله عنهما، ورغم كل هذه الفروق في الأمزجة والطبائع أقاموا أخوّة ملحميّة فيما بينهم، وبحسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا“[4] كانوا متشابكين بإحكام مع بعضهم البعض، وحتى وإن وقع بينهم موقفٌ غير لائق أحيانًا فسرعان ما كانوا يعالجونه، وقد صار هذا المجتمع بطلَ الإرادة بفضل قدرته على استيعاب الوحي جيّدًا.
فلو أننا جعلنا الإيمان والإسلام والإحسان جزءًا من فطرتنا لاستطعنا ترقيق حدّة طبعنا، وتهذيب مشاعرنا السلبية شيئًا فشيئًا، وأدركنا حينئذ أن ما كنا نعتبره مشكلة حتى ذلك اليوم لم يكن كذلك في الحقيقة، واستوعبنا فكرة خلقِ الله تعالى كلَّ إنسانٍ على مزاجٍ مختلِفٍ وطبيعةٍ متباينةٍ، وقيّمنا تصرفات الآخرين وسلوكياتهم بمعايير الدين وليس بمعاييرنا الذاتية.
ولا ننسَ أن الإنسان جُبِل على اقتراف الذنوب وارتكاب الأخطاء، وأن له عدوين لدودين هما النفس والشيطان.. فإذا توقعنا أنه سيظلّ طوال حياته لا ينحرف عن الاستقامة ولن يقترف أيّ ذنبٍ؛ فقد نُصاب بخيبة أمل؛ حيث إن كلَّ شيءٍ متوقَّعٌ من الإنسان؛ لأنه مخلوقٌ مؤهّل للتنقل في ساحةٍ واسعة بين أعلى عليين -وهي أرفع مكانة يمكن لمخلوق أن يصل إليها- وبين أسفل سافلين -وهي أحطّ وأدنى دركة يمكن لمخلوق أن يتدنى إليها- فينبغي أن يسلِّم الإنسان بهذه الحقيقة في البداية، وأن يقيم علاقاته مع الناس على هذا الأساس، وأن يأخذ في اعتباره ما يمكن أن يصدر منهم من سلبيات.
فهل يأمن أحدُنا على نفسه في هذا الموضوع؟! أو مَن منا يودّ أن تُكشف عيوبه وتظهر أخطاؤه؛ فيبتعد عنه أصدقاؤه؟! يجب أن نعلم جيدًا أن ما نتوقّعه من الناس يتوقّعه الناس منّا أيضًا، المهمّ هو أن نعرف كيفية التعامل مع الناس على الرغم من اختلافاتهم وأخطائهم وعيوبهم، وأن نجد وسيلةً للتوافق معهم، وألا نسمح للسلبيات بأن تفسد الوحدة والتضامن فيما بيننا.
أولى الأولويات
يجب على الذين استهدفوا أعلى مرتبةٍ -وهي رضا الله- وحصروا همتهم على أسمى هدف -وهو دعوة الناس إلى الله- أن يكونوا متسامحين أكثر مع رفقاء دربهم لا سيما على من نذروا أنفسهم، والذين يتبنَّون هذه الفكرة لا يضخّمون الأشياء الصغيرة، ولا يجعلون من اللامشكلةِ مشكلةً، ولا يفسدون الأخوّة التي فيما بينهم، لأنهم يعلمون أن طريق الحق تحفّه بعض الصعوبات والمشقات ويتحملون ويصبرون على هذا، نظرًا لأنهم يعلمون أن الوفاق والاتفاق هما أعظم وسيلة للفوز بالتوفيق الإلهي فإنهم لا يحوِّلون وفاقهم واتفاقهم إلى خلافات وصراعات؛ حتى لا يكونوا حجر عثرةٍ أمام عناية الله.
من المتعذر اليوم أن نقول: لقد تمكّنّا من تأسيس أخوّة قويّة بالقدر الذي تحقّق بين المهاجرين والأنصار، ورغم هذا فإن قدرتَنا على السير في هذا الطريق دون صراعٍ أو خلافٍ كبير بيننا يُظهر بوضوح أن عنايةً من الله تشملنا.. فإذا كان الله تعالى يقابل هذا القدر الزهيد من الأخوّة بهذا القدر الوافر من العناية والرعاية؛ فربما لا تقع بيننا مشاكل كبيرة بفضل الأخوّة القويّة الصادقة التي سنعزّزها فيما بيننا، ومَنْ يدري! فقد يتفضّل المولى علينا بألطافٍ ونِعَمٍ كثيرة، وحينذاك نحن أيضًا لن نهدر قوتنا وطاقتنا بمحاولة معالجة المشاكل والاضطرابات فيما بيننا وتعويضها، ولكن سنستخدمها للقيام بتنفيذ خدماتنا على نطاق أوسع فأوسع.
إن إقامة روح الأخوة على المستوى المطلوب تعتمد على التركيز خاصةً ودومًا على الأخوة وتحفيز الناس على ذلك. أجل، يجب أن نركّز باستمرار على فكرة الإيمان وشعور الأخوّة وفلسفة الخدمة؛ بغض النظر عن الأسماء والألقاب والنظام والأداء والبيروقراطية والإدارة، وأن نبذل جهودنا لتطوير هذه المفاهيم بكل جوانبها في الأرواح، وأن نُعِدّ البرامج ونطوِّر الأنظمة وننشئ المنظمات من أجل إنعاش هذه الجهود والمساعي، ولا بد أن يكون الموضوع الأساس في اجتماعاتنا هو مذاكرة المسائل المتعلقة بالله ورسوله والدين والإيمان، لا بدّ أن نركّز على هذه الأمور لدرجة أننا ننسى ما لا بد أن نناقشه أحيانًا من أجل الخدمة، ولا نتذكّره إلا أثناء الخروج من الباب، وعندها نقول مثلًا: “لقد سمحوا لنا بفتح خمس مدارس في المكان الفلاني”، أو نقول: “ما دمنا قد اجتمعنا فلنتشاورْ حول هذه المسألة أيضًا”.
إننا مع الأسف قد أفسدنا ترتيب الأولويات، واعتقدنا أن القضايا الثانوية هي القضايا الأصلية، ومن ثم فعلينا أن نعلم أننا إذا أخّرنا ما لا بدّ من تقديمه، وقدّمنا ما لا بدّ من تأخيره؛ فلن نتخلّص من الصراعات والنزاعات، ولن نتغلّب على المشاكل والاضطرابات.. فبعضُ المشاكل التي نشهدها اليوم تكمن وراءها مثل هذه الأسباب.. فإن وضعَ الإستراتيجيات وإعدادَ البرامج وتنظيمَ الأنشطة وغيرها من القضايا المهمّة التي تصبّ في مصلحة الخدمة ليست هي القضايا الأكثر أهمّية لدينا.. إن أهم شيءٍ بالنسبة لنا هو أن نحافظ على ذاتيتنا، وأن نتغذى روحيًّا، وأن نكتشف أعماقنا مرّة أخرى، وأن نبتغي بذلك رضا الله دائمًا، وأن نحرص على القيام بما يحملنا إلى أفق الرضا، أو كما نقول دومًا: الحديث عن الحبيب جل وعلا.
[1] بديع الزمان سعيدد النورسي: المكتوبات، المكتوب الثاني والعشرون، ص 321.
[2] بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، نوى الحقائق، ص 372.
[3] صحيح مسلم، الجنة، 1.
[4] صحيح البخاري، الصلاة، 87؛ صحيح مسلم، البر والصلة، 65.